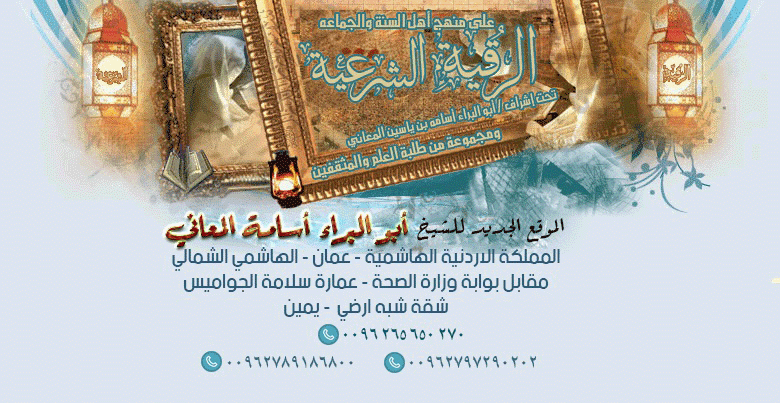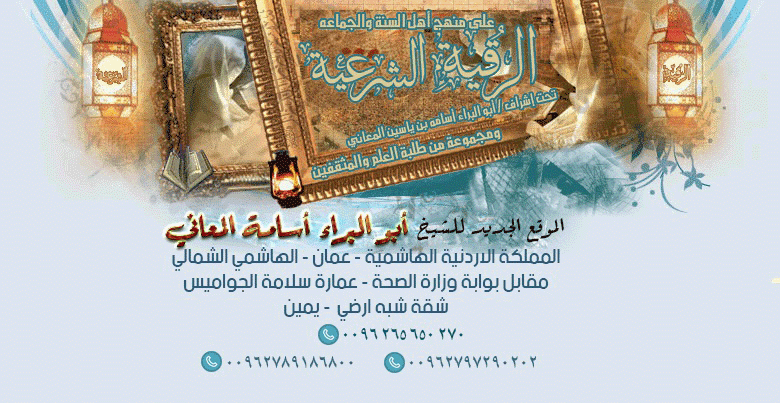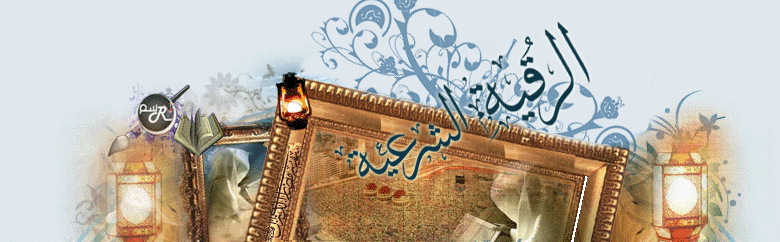* تتمــــة :
الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغيره من الاختلافات الفقهية الاجتهادية،
وربما يكون اختلافاً لفظياً في بعض الأحيان من أجل تطبيق الحكم على الشخص المعين،
أي إن الجميع يتفقون على أن هذا القول كفر،
أو هذا الفعل كفر، أو هذا الترك كفر،
ولكن هل يصدق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام المقتضي في حقه وانتفاء المانع أو لا ينطبق لفوات بعض المتقضيات،
أو وجود بعض الموانع .
وذلك أن الجهل بالمكفر على نوعين :
الأول : أن يكون من شخص يدين بغير الإسلام
أو لا يدين بشيء ولم يكن يخطر بباله أن ديناً يخالف ما هو عليه فهذا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا،
وأما في الآخرة فأمره إلى الله تعالى والقول الراجح أنه يمتحن في الآخرة بما يشاء الله عز وجل والله أعلم بما كانوا عاملين،
لكننا نعلم أنه لن يدخل النار إلا بذنب
لقوله تعالى : ** ولا يظلم ربك أحداً ** .
سورة الكهف 49
وإنما قلنا : تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا وهي أحكام الكفر، لأنه لا يدين بالإسلام فلا يمكن أن يعطى حكمه،
وإنما قلنا بأن الراجح أنه يمتحن في الآخرة لأنه جاء في ذلك آثار كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه : " طريق الهجرتين "
عند كلامه على المذهب الثامن في أطفال المشركين تحت الكلام على الطبقة الرابعة عشرة.
النوع الثاني : أن يكون من شخص يدين بالإسلام ولكنه عاش على هذا المكفر ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام،
ولا نبهه أحد على ذلك فهذا تجري عليه أحكام الإسلام ظاهراً،
أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل .
وقد دل على ذلك الكتاب، والسنة،
وأقوال أهل العلم :
فمن أدلة الكتاب : قوله تعالى :
** وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ** .
وقوله : ** وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون ** .
وقوله : ( رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ** ،
وقوله :
** وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ** .
وقوله : ** وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ** .
وقوله : ** وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون * أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين * أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدىً ورحمة **
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الحجة لا تقوم إلا بعد العلم والبيان .
وأما السنة : ففي صحيح مسلم 1 / 134
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال :
( والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة - يعني أمة الدعوة - يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار ) .
وأما كلام أهل العلم :
فقال في المغني 8 / 131 : « فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام،
والناشئ بغير دار الإسلام،
أو بادية بعيدة عن الأمصار
وأهل العلم لم يحكم بكفره » .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى
3 / 229 مجموع ابن قاسم :
« إني دائماً ومن جالسني يعلم ذلك مني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى تكفير، وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة، وفاسقاً أخرى، وعاصياً أخرى،
وإني أقرر أن الله تعالى قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية، والمسائل العملية،
وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر، ولا بفسق، ولا بمعصية
- إلى أن قال - :
وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضاً حق ، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين
- إلى أن قال - : والتكفير هو من الوعيد فإنه وإن كان القول تكذيباً لما قاله الرسول، صلى الله عليه وسلم، لكن الرجل قد يكون حديث عهد بإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة،
وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئاً » اهـ .
وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب
1/ 56 من الدرر السنية :
« وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول، ثم بعدما عَرَفَه سَبّهُ، ونهى الناس عنه، وعادى من فعله فهذا هو الذي أكفره » .
وفي ص 66 :
« وأما الكذب والبهتان فقولهم : إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله،
وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر، والصنم الذي على أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم، وعدم من ينبههم
فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل » اهـ .
وإذا كان هذا مقتضى نصوص الكتاب، والسنة، وكلام أهل العلم فهو مقتضى حكمة الله تعالى ولطفه، ورأفته، فلن يعذب أحداً حتى يعذر إليه،
والعقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله تعالى من الحقوق، ولو كانت تستقل بذلك لم تتوقف الحجة على إرسال الرسل .
فالأصل فيمن ينتسب للإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي،
ولا يجوز التساهل في تكفيره لأن في ذلك محذورين عظيمين :
أحدهما : افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به .
أما الأول فواضح حيث حكم بالكفر على من لم يكفره الله تعالى فهو كمن حرم ما أحل الله،
لأن الحكم بالتكفير أو عدمه إلى الله وحده كالحكم بالتحريم أو عدمه .
وأما الثاني فلأنه وصف المسلم بوصف مضاد، فقال : إنه كافر،
مع أنه بريء من ذلك وحري به أن يعود وصف الكفر عليه لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال :
( إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما ) .
وفي رواية :
( إن كان كما قال وإلا رجعت عليه ) .
وله من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال :
( ومن دعا رجلاً بالكفر، أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه ) .
يعني رجع عليه.
وقوله في حديث ابن عمر:
( إن كان كما قال )
يعني في حكم الله تعالى
وكذلك قوله في حديث أبي ذر :
( وليس كذلك )
يعني في حكم الله تعالى .
وهذا هو المحذور الثاني أعني عود وصف الكفر عليه إن كان أخوه بريئاً منه ،
وهو محذور عظيم يوشك أن يقع به ،
لأن الغالب أن من تسرع بوصف المسلم بالكفر كان معجباً بعمله محتقراً لغيره فيكون جامعاً بين الإعجاب بعمله الذي قد يؤدي إلى حبوطه،
وبين الكبر الموجب لعذاب الله تعالى في النار كما جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال

قال الله عز وجل : الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار ) .
_ أخرجه الإمام أحمد ج 2 ص 376،
وأبو داود : كتاب اللباس : باب ما جاء في الكبر، وابن ماجه : كتاب الزهد : باب البراءة من الكبر.
_ مجموع الفتاوى ( م 7 ص ج 37 - 42 )