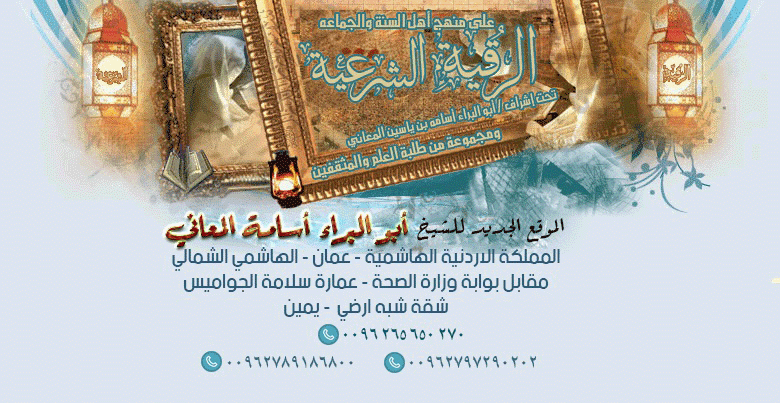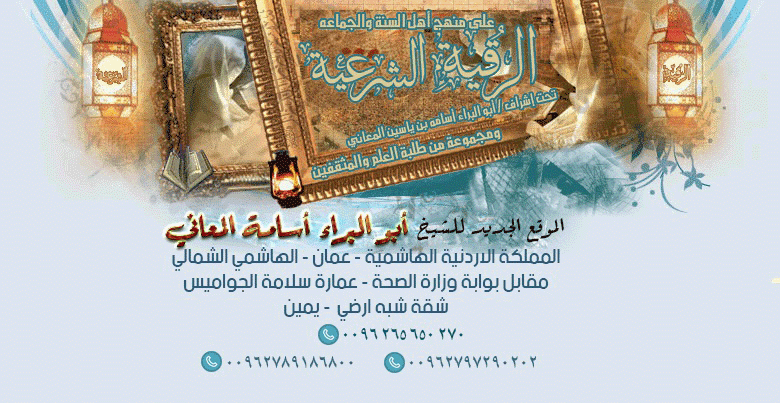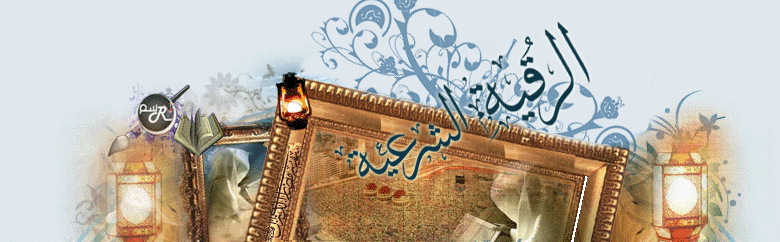الأسئلة والأجوبة الفقهية
55- باب صلاة الجمعة
س370: ما حكم صلاة الجمعة؟ وما الأصل في فرضها؟ ولم سميت جمعة؟
ج: أولاً: الجمعة سميت جمعة، قيل: لجمعها الخلق الكثير، وقيل: إنما سميت جمعة لجمعها الجماعات، وهو قريب من الأول، وقيل: لجمع طين آده فيها، وقيل: لأن آدم جمع فيها خلقه، قال الزركشي: واشتقاقها من اجتماع الناس للصلاة قاله ابن دريد. وقيل: بل لاجتماع الخليفة فيه وكمالها. ويروى عنه -عليه أفضل الصلاة والسلام- «أنها سميت بذلك لاجتماع آدم فيه مع حواء في الأرض» انتهى من «الإنصاف» ؛ وأما الأصل في مشروعيتها فهو الكتاب والسُّنة والإجماع؛ وأما الكتاب: فقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا البَيْعَ** فأمر بالسعي ويقتضي الأمر الوجوب، ولا يجب السعي إلا إلى الواجب، ونهى عن البيع لئلا يشتغل به عنها، فلو لم تكن واجبة لما نهى عن البيع من أجلها؛ وأما السُّنة فعن ابن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: «لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم» رواه أحمد ومسلم، وعن أبي هريرة وابن عمر أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين» رواه مسلم، ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن عمر وابن عباس، وعن أبي الجعد الضمري، وله صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ترك ثلاث جمع تهاونًا طبع الله على قلبه» رواه الخمسة، ولأحمد وابن ماجه من حديث جابر ونحوه.
وإياك والتفريط في جمعة بها ... قد اختص رب الخلق أمة أحمد
ففي يومها يعطي المزيد لفائز ... فينظر من غير كيف فقيد
وفي تركها من غير عذر ثلاثة ... يران على قلب الغفول البعد
س371: على من تجب صلاة الجمعة؟ وهل تجب على العبد؟
ج: تجب على كل ذكر مسلم مكلف مستوطن ببناء يشمله اسم واحد؛ أما كونه مسلمًا مكلفًا، فلأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف والعبادة، فلا تجب على مجنون إجماعًا، ولا على صبي في الصحيح من المذهب، لما روى طارق بن شهاب مرفوعًا: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض» رواه أبو داود؛ وأما كونه ذكر فلأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال؛ وأما كونها لا تجب على المسافر، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير.
وأما العبد، فقيل: لا تجب عليه الجمعة، لحديث طارق ابن شهاب وتقدم، ولما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريضًا أو مسافرًا أو امرأة أو صبيًا أو مملوكًا» رواه الدارقطني، والقول الثاني: أنها تجب عليه لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ** ، وعن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رواح الجمعة واجب على كل محتلم» رواه النسائي، وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الجمعة على من سمع النداء» رواه أبو داود والدارقطني، وقال فيه: «إنما الجمعة على من سمع النداء» ، وهذا القول عندي أنه أقوى دليلاً؛ لأن النصوص الصحيحة عامة في دخولهم. والله أعلم.
س372: هل الجمعة مستقلة أم بدل من الظهر؟ وما معنى كونها فرض الوقت؟
ج: هي مستقلة وليست بدلاً عن الظهر، ومعنى كونها فرض الوقت أي يتعين لها، فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الجمعة لم تصح ظهرهم؛ لأنهم صلوا ما لم يخاطبوا به وتركوا ما خوطبوا به كما لو صلوا العصر مكان الظهر.
س373: هل تؤخر الفائتة لخوف فوات الجمعة؟ وهل تقتضي الجمعة إذا فاتت؟
ج: نعم تؤخر فائتة لخوف فوتها؛ لأنه لا يمكن تداركها بخلاف غيرها من الصلوات، ولا تقضي إذا فاتت لكن الظهر بدل عنها.
س374: إذا حضر الجمعة مسافر أو امرأة أو خنثى، فما الحكم؟
ج: تجزئه عن الظهر لأن إسقاط الجمعة عنهم تخفيف فإذا صلاها فكالمريض إذا تكلف المشقة.
س375: إذا حضر الجمعة مريض ونحوه فهل تجب عليه؟ وهل تنعقد به؟
ج: إذا حضرها مريض أو خائف على نفسه، أو ماله، أو أهله أو نحوه ممن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة، وجبت عليه وانعقدت به وجاز أن يؤم فيها؛ لأن الساقط عنه الحضور للمشقة فإذا تكلفها وحضر تعينت عليه كمريض المسجد.
س376: إذا صلى الظهر من عليه حضور الجمعة، فما الحكم؟
ج: لا تصح صلاة الظهر يوم الجمعة ممن يلزمه حضورها بنفسه أو غيره قبل تجميع الإمام، ولا مع شكه في تجميع الإمام؛ لأنها فرض الوقت، فقد صلى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به أشبه ما لو صلى العصر مكان الظهر.
س377: إذا صلى المعذور قبل تجميع الإمام ثم زال عذره قبل تجميع الإمام، فما الحكم؟
ج: تصح من معذور قبل تجميع الإمام بشرط أنه قد دخل وقت الظهر؛ لأنه فرضه وقد أداه ولو زال عذره قبله كمعضوب حج عنه ثم عوفي إلا الصبي إذا بلغ، والأفضل لمن لا تجب عليه أن يؤخر الصلاة حتى يصلي الإمام الجمعة فيصلي بعده.
س378: بين حكم السفر في يوم الجمعة؟ واذكر الدليل أو التعليل على ما تقول؟
ج: يحرم سفر من تلزمه في يومها بعد الزوال حتى يصلي الجمعة لاستقرارها في ذمته بدخول وقتها، فلم يجز له تفويتها بالسفر بخلاف غيرها من الصلوات لإمكان فعلها حال السفر إن لم يخف فوت رفقته؛ فإن خافه سقط عنه وجوبها وجاز له السفر؛ وأما قيل الزوال فيكره لمن هو من أهل وجوبها خروجًا من الخلاف ولم يحرم، لقول عمر - رضي الله عنه -: «لا تحبس الجمعة عن سفر» رواه الشافعي في «مسنده» وكما لو سافر من الليل، ولأنها لا تجب إلا بالزوال وما قبله وقت رخصة ومحل الكراهة إن لم يأت مسافر بها في طريقه؛ فإن أتى بها في طريقه لم يحرم.
س379: ما هي شروط صحة صلاة الجمعة؟
ج: شروط صحتها أربعة: أحدها: الوقت. ثانيًا: حضور العدد المعتبر. ثالثًا: أن يكونوا بقرية مستوطنين. رابعًا: تقدم خطبتين.
س380: ما أول وقت الجمعة وما آخره؟ ومتى تلزم؟ ودلل على ما تقول.
ج: يدخل وقتها من أول وقت صلاة العيد، أي من ارتفاع الشمس قيد رمح، وآخره آخر وقت الظهر، وتلزم بالزوال؛ لأن ما قبله وقت جواز؛ أما الدليل على أول وقتها، فلحديث عبد الله بن أسيد السلمي قال: «شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدته مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدًا عاب ذلك ولا أنكره» رواه الدارقطني وأحمد واحتج به، قال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر فكان إجماعًا. وعن جابر «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريح حين تزول الشمس» رواه أحمد ومسلم، وعن سهل ابن سعد قال: «ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة» رواه الجماعة.
وقيل: إن أول وقتها كوقت الظهر بعد الزوال، لما ورد عن سلمة
ابن الأكوع - رضي الله عنه - قال: «كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء» أخرجاه، وعن أنس - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس» رواه أحمد والبخاري، وأبو داود والترمذي.
وفعلها بعد الزوال أفضل خروجًا من الخلاف، ولأنه الوقت الذي كان صلى الله عليه وسلم يصليها فيه في أكثر أوقاته. والله أعلم.
س381: بين الحكم إذا شك في خروج الوقت؟ وإذا لم يتم العدد المعتبر إلا بالإمام.
ج: لا تسقط الجمعة بشك في خروج الوقت؛ لأن الأصل عدمه والوجوب محقق، وإذا كان الإمام من أهل وجوبها فيتم به العدد ويصلون جمعة، لقول كعب بن مالك: «أول من جمع بنا سعد بن زرارة في هزم النبيت في نقيع يقال له: نقيع الخضمات. قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلاً» رواه أبو داود.
قال ابن جريج: قلت لعطاء: أكان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وقال أحمد: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا أربعين وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة. وقال جابر: «مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق جمعة وأضحى وفطر» رواه الدارقطني. وقيل: تنعقد باثنين، واستدلوا بأن العدد واجب بالحديث والإجماع، ورأوا أنه لم يثبت دليل شرعي على اشتراط عدد مخصوص، وقد صحت الجماعة في سائر الصلوات باثنين ولا فرق بينها وبين الجماعة، ولم يأت نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذا، وقيل: بثلاثة اختاره الأوزاعي، والشيخ تقي الدين، لقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ** وهذا جمع وأقله ثلاثة، وقيل: بخمسين،
لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «لما بلغ أصحا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسين جمع بهم» رواه النجاد. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم.
س382: ما الذي تدرك به الجمعة؟ وما الذي تدرك به صلاتها؟
ج: تدرك بإدراك ركعة قبل خروج وقتها، لما تقدم في حديث أبي هريرة وعائشة في جواب سؤال سابق، وكذا صلاتها لا تدرك إلا بإدراك ركعة، لما ورد عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته» رواه النسائي، وابن ماجه، والدارقطني، واللفظ له وإسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم إرساله.
ولما روى البيهقي عن أبي مسعود، وابن عمرو عن أبي هريرة مرفوعًا: «من أدرك ركعة من الجمعة، فقد أدرك الصلاة» رواه الأثرم، وتقدم بعض الأدلة في جواب سؤال سابق.
س383: ماذا يلزم من أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود بالأرض؟
ج: يلزمه السجود مع إمامه ولو على ظهر أخيه، أو رجله، لقول عمر «إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه» رواه أبو داود الطيالسي، وسعيد، وكالمريض يأتي بما يمكنه ويصح؛ فإن لم يمكنه السجود على ظهر إنسان أو رجله، فإذا زال الزحام سجد بالأرض ولحق إمامه إلا أن يخاف فوت الركعة الثانية مع الإمام؛ فإن خافه فإنه يتابعه فيها وتصير ثانية الإمام أولاه ويتمها جمعة.
س384: إذا لم يتابع المأموم المزحوم في الثانية مع خوف فوتها، فما الحكم؟
ج: إن لم يتابعه المأموم المزحوم في الثانية مع خوف فوتها عالمًا بتحريمه بطلت صلاته، لتركه واجب المتابعة بلا عذر، وإن جهل تحريم عدم متابعته
فسجد سجدتي الركعة الأولى ثم أدرك الإمام في التشهد أتى بركعة ثانية بعد سلامه وصحت جمعته؛ لأن أدرك مع الإمام منها ما تدرك به الجمعة وهو ركعة.
س385: ما حكم صلاتهما فيما قارب البنيان من الصحراء؟
ج: تصح إقامتها فيه؛ «لأن أسعد بن زرارة أول من جمع في حرة بني بياضة» أخرجه أبو داود والدارقطني، قال البيهقي: حسن الإسناد صحيح، قال الخطابي: حرة بني بياضة على ميل من المدينة.
س386: إذا نقص العدد المعتبر قبل إتمام الجمعة، فما الحكم؟ وإذا أدرك مع الإمام منها أقل من ركعة، فما الحكم؟
ج: إن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرًا إن لم يمكن فعل الجمعة مرة أخرى، ومن أدرك مع الإمام منها أقل من ركعة يتمها ظهرًا إذا كن نوى صلاة الظهر ودخل وقتها وإلا انقلبت نفلاً؛ أما في الأولى فكمن أحرم بفرض فبان قبل وقته.
وأما في الثانية فلحديث: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» ولأن الظهر لا تتأدى بنية الجمعة ابتداء فكذا استدامة.
س387: بين ما تستحضره من شروط لصحة الخطبتين مع ذكر ما تستحضره من خلاف؟
ج: أولاً: تذكر دليلاً للخطبتين، قال تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ** والذكر هو الخطبة، فأمر بالسعي إليها فيكون واجبًا، لمواظبته –عليه الصلاة والسلام- عليها مع قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ، وعن عمر وعائشة -رضي الله عنهما - «قصرت الصلاة من أجل الخطبة» ، وعن جابر بن سمرة قال: «كانت للنبي خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس فكانت صلاته قصدًا وخطبته قصدًا» رواه مسلم. وعن ابن عمر قال:
«كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائمًا ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم» رواه الجماعة، ومما يشترط حمد الله، وذلك لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم –أي مقطوع- البركة» رواه أبو داود، ورواه الجماعة مرسلاً.
وروى أبو داود عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد قال: «الحمد له» » .
ويتعين هذا اللفظ في قول الجمهور، وقال جابر: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بحمد الله ويثني عليه بما هو أهله» الحديث.
ثانيًا: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختار لشيخ تقي الدين أن الصلاة عليه –أفضل الصلاة والسلام- واجبة لا شرط، قاله في «الإنصاف» .
وقال في «الشرح الكبير» : ويحتمل أن لا تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك في خطبته. اهـ.
والدليل على ذلك: أن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر نبيه كالأذان؛ ولأنه قد روي في تفسير قوله تعالى: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ** قال: لا أذكر إلا ذكرت معي. ويتعين لفظ الصلاة أو يشهد أنه عبد الله ورسوله.
ثالثًا: قراءة آية من كتاب الله عز وجل، لما روى جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس» رواه مسلم، ولما روى الشعبي قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس، وقال: «السلام عليكم» ويحمد الله ويثني عليه ويقرأ سورة، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب ثم ينزل وكان أبو بكر وعمر يفعلانه»
رواه الأثرم، وقيل: لا يشترط قراءة آية، فلو قرأ ما تضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه.
رابعًا: الوصية بتقوى الله عز وجل؛ لأنها المقصود بالخطبة، فلم يجز الإخلال بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم. وعن جابر بن سمرة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائمًا ويجلس بين الخطبتين ويقرأ آيات ويذكر الناس» روه الجماعة إلا البخاري والترمذي، وعنه أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه كان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هي كلمات يسيرات» رواه أبو داود.
خامسًا: موالاتهما مع الصلاة؛ لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم خلافه، وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ولما ورد لأحمد والنسائي «كان بلال يؤذن إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقيم إذا نزل» وهذا يدل على الموالاة.
سادسًا: النية، لحديث: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» .
سابعًا: حضور العدد المعتبر، قال في «الشرح الكبير» : فصل ويشترط حضور العدد المشترط في القدر الواجب من الخطبتين، وقال أبو حنيفة في رواية أبي داود عنه: لا يشترط؛ لأنه ذكر يتقدم الصلاة فلم يشترط له العدد؛ كالأذان ولنا أنه ذكر من شرائط الجمعة فكان من شرطه العدد، وكتكبيرة الإحرام ويفارق الأذان؛ فإنه ليس بشرط، وإنما مقصوده الإعلام والإعلام للغائبين، والخطبة مقصودها الموعظة فهي للحاضرين. اهـ. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم.
س388: اذكر ما تستحضره من سنن الخطبتين، والأدلة الدالة على ذلك؟
ج: أولاً: الطهارة من الحدث والجنابة، فتصح خطبة جنب كأذانه، وعنه أنها من شرائطها؛ لأنه –عليه الصلاة والسلام- لم يكن يفصل بين الخطبة والصلاة بطهارة، فدل على أنه كان متطهرًا.
ثانيًا: ستر العورة.
ثالثًا: إزالة النجاسة قياسًا؛ لأن الخطبتين بدل ركعتين؛ لقول عمر وعائشة: «قصرت الصلاة لأجل الخطبة» .
رابعًا: الدعاء للمسلمين «لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بأصبعه وأمن الناس» رواه حرب في مسائله؛ ولأن الدعاء لهم مسنون من غير الخطبة ففيها أولى.
خامسًا: أن يتولاهما من يتولى الصلاة.
قال أحمد في الإمام يخطب يوم الجمعة ويصلي الأمير بالناس: لا بأس إذا حضر الأمير الخطبة؛ لأنه لا يشترط اتصالها بها، فلم يشترط أن يتولاهما واحد كصلاتين.
سادسًا: رفع الصوت بهما حسب الطاقة، لما ورد عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته» الحديث رواه مسلم.
سابعًا: أن يخطب قائمًا على مرتفع معتمدًا على قوس أو عصا؛ أما الدليل على كونه قائمًا، فلقوله تعالى: {وَتَرَكُوكَ قَائِمًا** قال جابر بن سمرة: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائمًا، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائمًا» فمن نبأك أنه يخطب جالسًا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة، رواه أحمد ومسلم وأبو داود؛ وأما الدليل على كونه معتمدًا على قوس أو عصا، فلما ورد عن الحكم بن حزن الكلفي قال: «قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سابع سبعة أو تاسع تسعة فلبثنا عنده أيامًا شهدنا فيها الجمعة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئًا على قوس أو قال على عصا،
فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: «أيها الناس إنكم لن تفعلوا أو لن تطيقوا كل ما آمركم ولكن سددوا وابشروا» » رواه أحمد وأبو داود.
قال ابن القيم –رحمه الله في «زاد المعاد» (1/242) : ولم يكن يأخذ بيده سيفًا ولا غيره، وإنما يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر، وكان في الحرب يعتمد على قوس، وفي الجمعة على عصا، ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف ولم يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائمًا وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف فمن فرط جهله. اهـ.
قال الشيخ سليمان بن سحمان الناظم لبعض اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمهما الله-:
وما كان من هدي النبي اعتماده ... على السيف إذ لا نص فيه لمهتد
ولكن يكون الاعتماد على العصى ... أو القوس ذا هدى النبي محمد
وما ظنه الجهال أن اعتماده ... على السيف فيما يزعمون لمقصد
إشارة إظهار لدين أتى به ... فزعم بعيد الرشد غير مسدد
ثامنًا: أن يجلس بينهما قليلاً، لقول ابن عمر «كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس» متفق عليه؛ فإن أبى أو خطب وهو جالس فصل بينهما بسكتة ليحصل التمييز بينهما، وليست واجبة؛ لأن جماعة من الصحابة سردوا الخطبتين من غير جلوس منهم: المغيرة، وأبي بن كعب، قال أحمد: ولا بأس أن يخطب من صحيفة كقراءة في الصلاة من مصحف.
تاسعًا: قصر الخطبتين، لما روي عن عمار بن ياسر قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة» رواه أحمد ومسلم، وعن
جابر بن سمرة قال: «كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدًا وخطبته قصدًا» رواه الجماعة إلا البخاري، وأبا داود.
وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة ويقصر الخطبة» رواه النسائي.
عاشرًا:
أن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، لما روى ابن ماجه عن جابر - رضي الله عنه - قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم» رواه الأثرم عن أبي بكر، وعمر، وابن مسعود، وابن الزبير - رضي الله عنهم -، ورد هذا السلام وكل سلام فرض كفاية على المسلم عليهم، وقيل: سُّنة كابتدائه.
الحادي عشر: جلوسه حتى يؤذن، وذلك لما روى ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب» رواه أبو داود مختصرًا.
الثاني عشر: أن يقصد الخطيب تلقاء وجهه فلا يلتفت يمينًا وشمالاً لفعله صلى الله عليه وسلم؛ ولأنه أقرب إلى أسماعهم كلهم، ولا بأس أن يشير بأصبعه في الدعاء، لما ورد عن حصين بن عبد الرحمن قال: «كنت إلى جنب عمارة بن رويبة وبشر بن مروان يخطبنا، فلما دعا رفع يديه، فقال عمار: قبح الله هاتين اليدين، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب إذا دعا يقول هكذا فرفع السبابة وحدها» رواه أحمد والترمذي بمعناه وصححه.
س389: ما صفة صلاة الجمعة؟ وما دليلها؟
ج: صلاة الجمعة ركعتان، وذلك بالإجماع حكاه ابن المنذر، وقال عمر - رضي الله عنه -: «صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى» رواه أحمد، وابن ماجه يسن أن يجهر فيهما
بالقراءة. قال الأئمة: لفعله –عليه الصلاة والسلام- ونقله الخلف عن السلف. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «صلاة النهار عجماء إلا الجمعة والعيدين» .
س390: ما المسنون قراءته في صلاتها؟ وما هو الدليل عليه؟
ج: يسن أن يقرأ جهرًا في الأولى بالجمعة، وفي الثانية بالمنافقين بعد الفاتحة، وإن قرأ بالأولى بسبح، وفي الثانية بالغاشية فحسن، لما ورد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين» رواه مسلم، ولعن عن النعمان ن بشير قال: «كان يقرأ في العيدين والجمعة بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى** ، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ** » رواه أبو داود والنسائي.
س391: ما المسنون أن يقرأه في فجرها؟ وما الدليل عليه؟ وما الحكمة في ذلك؟
ج: يُسن أن يقرأ في فجرها (الم السجدة) ، وفي الركعة الثانية {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ** ، لما ورد عن ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح (الم تنزيل السجدة) ، و {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ** » الحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي، وعن أبي هريرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة (الم تنزيل) ، و {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ** » رواه الجماعة إلا الترمذي وأبا داود؛ ولكنه لهما من حديث ابن عباس، والحكمة قيل: لتضمنها ابتداء خلق السموات والأرض وخلق الإنسان.
س392: ما حكم إقامة الجمعة والعيدين في أكثر من موضع من البلد؟ وضح ذلك.
ج: تحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة؛ لأنهما لم يكونا يفعلا في عهده وعهد خلفائه إلا كذلك، وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» وإما لحاجة كضيق مسجد البلد، وكتباعد أقطار البلد فيشق على من منزله بعيد عن محل الجمعة، وكخوف فتنة ونحوه.
س393: إذا وقع عيد في يوم الجمعة فما الحكم؟ وما دليل الحكم؟ وضح ذلك
ج: إذا وقع عيد في يوم الجمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد مع الإمام سقوط حضور لا سقوط وجوب؛ وأما الإمام فلا يسقط عنه حضور الجمعة لما ورد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون» رواه أبو داود وابن ماجه، وعن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - وسأله معاوية: «هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا؟ قال: نعم، صلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة، فقال: «من شاء أن يجمع فليجمع» » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
س394: كم أقل السنة بعد الجمعة؟ وكم أكثرها؟ واذكر الأدلة على ما تذكر.
ج: أقل السُّنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان، لحديث ابن عمر مرفوعًا: «كان يصلي بعد الجمعة ركعتين» متفق عليه، وأكثرها ست ركعات، لقول ابن عمر: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله» رواه أبو داود، ولا راتبة لها قبلها ويستحب أربع ركعات، لما روى ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم كان يركع من قبل الجمعة أربعًا، وروى سعيد عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات وبعدها أربع ركعات، وقال عبد الله: رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعات، ويُسن أن يفصل بين السُّنة وبين الجمعة بكلام أو انتقال.
س395: بين إلى كم تنقسم خصائص الجمعة؟ ومثل لكل قسم.
ج: إلى ثلاثة أقسام: قسم قبل الصلاة.
القسم الثاني: في كل يومها.
القسم الثالث: بينهما بحسب ما ورد.
ومثال الأول: كالاغتسال والطيب.
ومثال الثاني: كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والذكر والدعاء.
ومثال الثالث: كقراءة سورة الكهف في يومها ومنه ساعة الإجابة.
س396: اذكر ما تستحضره مما يُسن قبل صلاة الجمعة وبعدها؟
ج: يُسن قراءة سورة الكهف في يومها، وكثرة دعاء وأفضله بعد العصر، وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغسل لها فيه وأفضله عند مضيه وتنظف وتطيب، ولبسُ أحسن ثيابه، وهو البياض، وتبكير غير إمام بعد طلوع الفجر ماشيًا إن لم يكن عذر، ولا بأس بركوبه لعذر وعود، وأن يخرج إليها على أحسن هيئة بسكينة ووقار مع خشوع، ويدنو من الإمام، وأن يستقبل القبلة وأن يشتغل بذكر الله تعالى، وأفضله قراءة القرآن.
س397: اذكر ما تستحضره من أدلة ما تقدم مما يُسن قبل صلاة الجمعة وبعدها؟
ج: أما دليل الغسل، فهو ما ورد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه وإن كان له طيب مس منه» رواه أحمد؛ وأما الطيب والإنصات، فهو ما ورد عن سلمان الفارسي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من ظهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يروج إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب الله له، ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة إلى الجمعة الأخرى» رواه أحمد والبخاري؛ وأما التبكير: فهو ما ورد عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنما قرب بدنة، ومن راح
في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومن راح من الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» رواه الجماعة إلا ابن ماجه؛ وأما الدنو من الإمام، فلما ورد عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «احضروا الذكر وادنوا من الإمام؛ فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها» رواه أحمد وأبو داود.
وأما دليل الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فيها فهو ما ورد عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة وفيه الصعفة، فأكثروا علي من الصلاة فيه» الحديث رواه الخمسة إلا الترمذي.
وأما الدليل على كثرة الدعاء، فهو ما ورد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل خيرًا إلا أعطاه إياه، وقال: بيده قلنا يقللها يعني يزدهدها» رواه الجماعة إلا أن الترمذي وأبا داود لم يذكر القيام ولا تقليلها؛ وأما الدليل على استحباب قراءة سورة الكهف، فهو ما روى البيهقي بإسناد حسن عن أبي سعيد مرفوعًا: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين» ؛ وأما المشي إليها بسكينة ووقار، فلما ورد عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار» الحديث متفق عليه؛ وأما استقبال القبلة، فلما أخرجه الطبراني بإسناد حسن عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لكل شيء سيدًا وإن سيد المجالس قبالة القبلة» وأخرج نحوه في «الأوسط» من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدعو في الاستسقاء
استقبل القبلة كما في البخاري وغيره، وقد استقبل القبلة صلى الله عليه وسلم في غير موطن كما في يوم بدر.
س398: متى يجب السعي إلى الجمعة؟ واذكر الدليل.
ج: يجب السعي إليها بالنداء الثاني الذي بين يدي الخطيب، لقوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ** الآية؛ لأنه الذي كان على عهده صلى الله عليه وسلم، ولا يجب بالأول؛ لأنه مستحب، ولأن عثمان سنه وعملت به الأمة.
س399: ما حكم تخطي رقاب الناس؟ وما دليل الحكم؟
ج: يكره أن يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إمامًا فلا يكره أو إلى فرجة لا يصل إليها إلا به، والدليل على الكراهة قوله –عليه الصلاة والسلام- وهو على المنبر لرجل رآه يتخطى رقاب الناس: «اجلس فقد آذيت» رواه أحمد؛ وأما من رأى فرجة فيباح إلى أن يصل غليها لإسقاطهم حقهم بتأخرهم عنها.
س400: ما حكم إيثار الإنسان غيره بمكانه الفاضل؟ وما حكم وضع مصلى في المسجد؟
ج: يكره إيثار غيره بمكان أفضل ويجلس فيما دونه؛ لأنه رغبة عن الخير، ولا يكره للمؤثر قبوله ولا رده، وقام رجل لأحمد من موضعه فأبى أن يجلس فيه، وقال: ارجع إلى موضعك، فرجع إليه، نقله سندي.
وأما فرش المصلى، فقال في «الاختيارات الفقهية» في (ص81) : وإذا فرش مصلى ولم يجلس عليه ليس له ذلك ولغيره رفعه في أظهر قولي العلماء.
قلت: ومثله وضع النعل والعصا، وتقديم الخادم والولد ثم إذا حضر قام عنه وجلس فيه، فهذا لا يجوز فيما أرى. والله أعلم.
قال الشيخ سليمان بن سحمان الناظم لبعض اختيارات شيخ الإسلام:
ووضع المصلى في المساجد بدعة ... وليس من الهادي القويم محمد
وتقديمه في الصف حجر لروضة ... وغضب لها عن داخل متعبد
ويشبهه وضع العصا وحكمها ... كحكم المصلى في ابتداع التعبد
بلى مستحب أن يمطا ويرفعا ... عن الداخلين الراكعين بمسجد
لئن لم يكن هذا بنص مقرر ... ولا فعل أصحاب النبي محمد
فخير الأمور السالفات على الهدى ... وشر الأمور المحدثات فبعد
س401: إذا قام إنسان في موضعه وزاحمه عليه آخر فأيهما أحق؟
ج: من قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبًا فهو أحق به، لحديث مسلم عن أبي أيوب مرفوعًا: «من قام من مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به، ومن لم يصل إليه إلا بالتخطي فكمن رأى فرجه» .
س402: ما حكم إقامة الغير من مكانه والجلوس فيه؟
ج: يحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه ولو عبده الكبير أو ولده الكبير أو كانت عادته الصلاة فيه حتى المعلم، لحديث ابن عمر - رضي الله عنه -: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه» متفق عليه.
ولا يتخطى الناس إلا إمامهم ... وراء مكانًا خاليًا في المؤكد
ويحرم رفع الغير عن بقعة له ... ويكره إيثار المساوي بمقعد
س403: ما حكم تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب؟
ج: تسن تحية المسجد ركعتان لكل من دخله قصد الجلوس أو لا غير خطيب دخل للخطبة، وغير داخله والإمام في مكتوبة، وبعد شروع في إقامة، وغير داخل المسجد الحرام؛ لأن تحيته الطواف وينتظر من دخل حال الأذان فراغ مؤذن لتحية مسجد ليجيب المؤذن ثم يصليها ليجمع بين الفضيلتين، وإن جلس قبل التحية قام فأتى بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «قم فاركع ركعتين» متفق عليه من حديث جابر؛ فإن طال الفصل فات محلها، وتقدم حديث أبي قتادة في باب أوقات النهي.
س404: ما حكم الكلام والإمام يخطب؟
ج: يحرم الكلام والإمام يخطب إن كان المتكلم من الإمام بحيث يسمعه إلا له أو لمن كلمه لمصلحة ويجب الكلام والإمام يخطب لتحذير ضرير عن هلكة، وتحذير غافل عن هلكة وبئر ونحوه كقطع الصلاة لذلك وأولى ويباح إذا سكت الخطيب بين الخطبتين وإذا شرع في الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر.
س405: اذكر ما تستحضره من الأدلة لما تقدم؟
ج: أما دليل التحريم في حق من هو منه بحيث يسمعه، فقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا** قال أكثر المفسرين: إنما نزلت في الخطبة، وسميت قرآنًا لاشتمالها عليه، ولخبر الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، واللغو الإثم» ، ولقوله: «من قال صه فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له» رواه أحمد وأبو داود، ولقوله صلى الله عليه وسلم في خبر ابن عباس: «والذي يقول أنصت ليس له جمعة» رواه أحمد، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء: «إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ» رواه أحمد؛ وأما الدليل على جوازه للخطيب أو لمن كلمه لمصلحة، فمن ذلك حديث أنس قال: «جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يوم الجمعة، فقال: متى الساعة؟ فأشار الناس إليه أن اسكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الثالثة: «ما أعددت لها؟» قال: حب الله ورسوله، قال: «إنك مع من أحببت» » رواه البيهقي بإسناد صحيح؛ ولأنه كلم سليكًا وكلمه هو رواه ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة، وسأل عمر، وعثمان فأجابه، وسأل العباس ابن مرداس الاستسقاء؛ ولأنه حال كلام الإمام وكلام الإمام إياه لا يشغل عن سماع الخطبة.